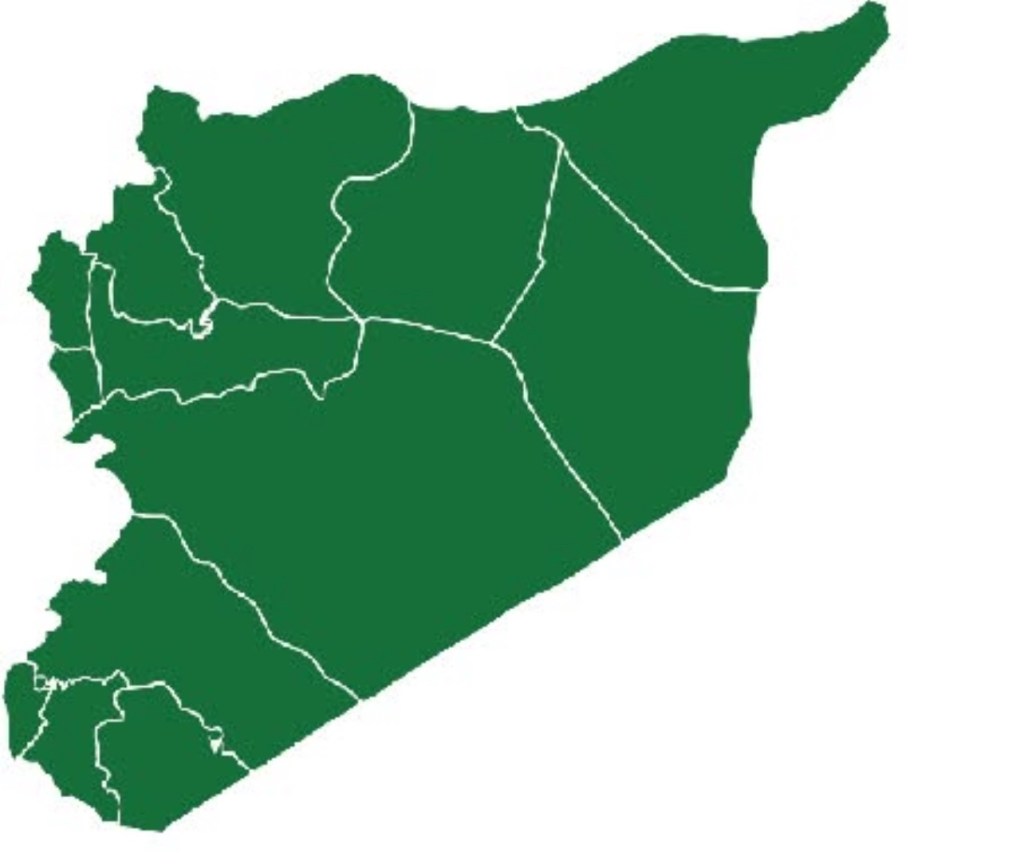
منذ عقود طويلة، تعيش سوريا أزمات اجتماعية متراكمة، تفاقمت مع الحرب حتى أصبحت تهدد النسيج الوطني بشكل غير مسبوق. لم يعد التعصب مجرد انحياز اجتماعي عابر، بل تحول إلى أداة صراع سياسي وأمني، حيث باتت الطائفية والعشائرية والعائلية تحدد مواقف الأفراد والجماعات، وأحياناً تُرتكب تحت رايتها جرائم مروعة. هذه النزعات لم تقتصر على مرحلة معينة، بل تجذرت عبر السنوات، حتى أصبحت معياراً يحدد شكل التحالفات والانقسامات داخل المجتمع.
مع اندلاع الثورة السورية، انقسم السوريون بين مؤيد للثورة ومناصر للنظام، وتجاوز الخلاف السياسي ليصل إلى صدامات مسلحة وارتكاب مجازر تحت شعارات مختلفة. البعض انضم إلى تنظيمات متشددة دينياً أو عرقياً، مارست أبشع أنواع العنف ضد الأبرياء، مستغلة غياب الدولة وتفكك مؤسساتها. ومع مرور الوقت، لم تعد هذه الاصطفافات مجرد مواقف سياسية، بل أصبحت جزءاً من هوية الأفراد، فبات اللجوء إلى الطائفة أو العشيرة أو العائلة هو الخيار الوحيد للحماية. لم يكن الأمر مجرد رد فعل، بل تحول إلى ثقافة، حتى بات الولاء للكيانات الضيقة يسبق العدالة والمنطق والوطن.
المشكلة لا تقتصر فقط على وجود التعصب، بل في تحوله إلى مبرر للظلم والتعدي. أصبح الانتماء للطائفة أو العشيرة فوق كل الاعتبارات، ولم يعد يُطرح السؤال عن صحة الفعل أو أخلاقيته، بل عن هوية مرتكبه. وهكذا، تراجع القانون أمام الانتماءات الضيقة، حتى لو كان الثمن هو تمزيق سوريا كدولة موحدة. في ظل هذا الواقع، نشأت تحالفات مشبوهة، حيث باتت بعض الفئات مستعدة لعقد صفقات مع أي طرف، حتى لو كان معادياً لمصالح الوطن، لتحقيق مكاسب آنية. هذه الظاهرة لم تقتصر على منطقة دون أخرى، بل امتدت من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، وجعلت المشهد أكثر تعقيداً.
مواجهة هذه الأزمة لا يمكن أن تكون عبر حلول سطحية أو إجراءات مؤقتة، بل تتطلب إعادة بناء مفهوم الدولة والمواطنة على أسس صحيحة. الانتماء إلى الوطن يجب أن يكون فوق أي انتماء آخر، بحيث يشعر كل مواطن أن حقوقه محفوظة بغض النظر عن طائفته أو عرقه. بناء دولة القانون هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، حيث يجب أن تكون العدالة المرجعية الأساسية، دون أي تمييز أو محاباة. لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي إذا كان الولاء للطائفة أو العشيرة يحمي مرتكبي الجرائم ويمنحهم امتيازات غير مستحقة.
إصلاح النظام التعليمي يعد ركيزة أساسية في بناء وعي وطني جامع، فمن الضروري أن تكون المناهج الدراسية خالية من الخطاب الطائفي والعرقي، وأن تركز على مفهوم المواطنة والانتماء للدولة. التعليم هو المدخل الأساسي لخلق أجيال لا ترى في الطائفة والعشيرة بديلاً عن الوطن، بل تعتبر التنوع ميزة يجب استثمارها في بناء مجتمع متماسك. إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال الدور الخطير للميليشيات المسلحة التي نشأت على أسس طائفية أو عشائرية، إذ يمثل تفكيكها شرطاً أساسياً لإعادة الاستقرار، بحيث يتم دمج أفرادها في مؤسسات الدولة وفق معايير عادلة، لا بناءً على المحسوبيات والانتماءات الضيقة.
لا يمكن لسوريا أن تتجاوز هذه المرحلة دون مصالحة وطنية حقيقية، قائمة على العدالة والمحاسبة، ولكن دون انتقام، مع إعطاء الفرصة لمن تورطوا في النزاع للعودة إلى حياتهم الطبيعية. أي مصالحة لا تقوم على محاسبة عادلة وإنصاف للضحايا لن تكون إلا هدنة مؤقتة ستتفجر مجدداً عند أول أزمة.
إلى جانب ذلك، لا يمكن معالجة التعصب بمعزل عن تحسين الوضع الاقتصادي، فالفقر والبطالة يشكلان بيئة خصبة للتطرف والانغلاق على الهويات الضيقة. خلق فرص عمل وتنمية المناطق المهمشة سيساهم في تقليل الحاجة إلى الاحتماء بالعشيرة أو الطائفة من أجل البقاء. الإعلام والمجتمع المدني لهما دور أساسي في تفكيك الفكر المتعصب، من خلال نشر ثقافة التعددية والتعايش، وإبراز الشخصيات التي تمثل نموذجاً للوحدة الوطنية، بدلاً من تضخيم الأصوات التي تكرس الانقسام.
الحالة السورية اليوم ليست مجرد صراع سياسي أو عسكري، بل هي أزمة هوية وطنية. المشكلة ليست في وجود طوائف أو أعراق أو عشائر، بل في استغلالها كأدوات للصراع بدلاً من أن تكون جزءاً طبيعياً من التنوع الذي يثري سوريا. الخروج من هذه الدوامة يتطلب إرادة حقيقية على مستوى السياسة والتعليم والاقتصاد والمجتمع المدني، وإلا فإن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من التشرذم والانهيار. الحل ليس مستحيلاً، لكنه يحتاج إلى رؤية بعيدة المدى تؤمن بأن سوريا لن تعود إلا إذا كان الانتماء الأول لها، لا للطائفة، ولا للعشيرة، ولا للعائلة.
بركات عُبيّد – ناشط اجتماعي ويدرس التربية الاجتماعية في إحدى جامعات ألمانيا.

اللهم إنا نستودعك سوريا، لانها سمانة بقلوبنا🇩🇿♥️
إعجابLiked by 1 person
ساكنة بقلوبنا
إعجابLiked by 1 person